تستمدّ اللغة العربية حياتها المعنوية ووهجها الحضاري والعقدي، ومنزلتها اللسانية والبيانية بين سائر اللغات الإنسانية، من الكتاب الكريم الذي تناهتْ إليه الخلاصةُ الأخيرة من الوحي الإلهي عبر مراحل مساره الزمني الطويل؛ ولهذا السبب فقد هيمنتْ على أرواح وقلوب وأفئدة مَن يدينون بالإسلام منذ الأزمان الغابرة، وقد بَلغتْنا عن أسلافنا القدماء، مقولاتٌ ومواقف تُترجم في مجملها عن حُبّ وإعزاز عارم للّغة العربية لا نكاد نجد له نظيراً في زمننا هذا، ولا نشك أنّ لهذه العلاقة دلالات عميقة، هي بمثابة بصمات على سلامة صحّة انتمائهم لهُويتهم وثقافتهم وأرومتهم. 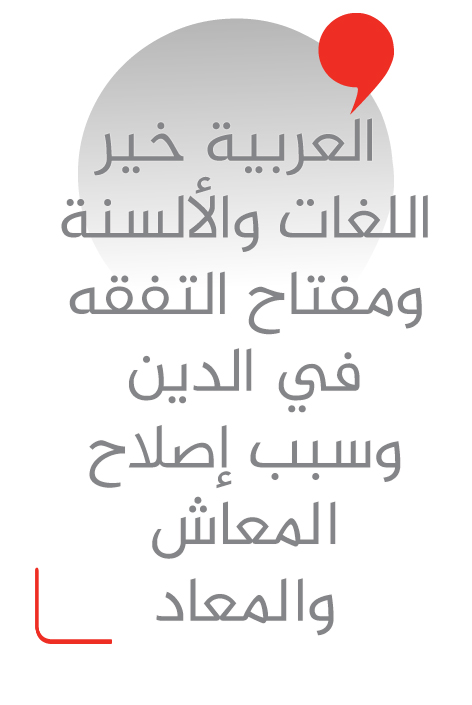
فهذا الإمام اللغوي أبو منصور الثعالبي النيسابوري رحمه الله، صاحب الأسفار النفيسة، التي منها: كتاب “فقه اللغة وسر العربية”، وكتاب “سر البيان”، وكتاب “سحر البلاغة وسر البراعة”، وكتاب “يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر” وغيرها كثير.. يعرض لهذه المسألة فيقول: “مَن أحبّ اللهَ تعالى أحبّ رسولَه صلى الله عليه وسلم، ومَن أحبّ الرسولَ العربي أحبّ العربَ، ومَن أحبّ العربَ أحبّ العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم، ومَن أحبَّ العربية عُني بها وثابر عليها، وصرفَ همته إليها، ومَن هداه الله للإسلام وشرحَ صدره للإيمان، وآتاه حسن سريرة فيه، اعتقد أن محمداً صلى الله عليه وسلم خير الرسل. والإسلام خير الملل. والعرب خير الأمم. والعربية خير اللغات والألسنة، وأنّ الإقبال على تفهّمها من الديانة، إذ هي أداة العلم، ومفتاح التفقه في الدين، وسبب إصلاح المعاش والمعاد”.
وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعتبر تعلّم اللغة العربية والتفقّه في أسرارها وآدابها وأساليبها، يوازي التفقّه في الدين، ويقول ” تفقهوا في الدين وتفقهوا في السُنّة، وتفقهوا في اللغة العربية، فإنها من دينكم “؛ كما كان يعتقد بأن الخطأ في الرمي أهونُ من الخطأ في اللغة.
وفي هذا المقام جاء في بعض الروايات التاريخية أن أمير المؤمنين مرّ على قوم يُسيئون الرمي، فأنّبهم على ذلك، فقالوا: يا أمير المؤمنين: إنا قوم متعلمين! -بدلاً من “متعلمون”- فضجر عمر رضي الله عنه مما سمع، ثم قال قولته المشهورة المدويّة: “والله لخطؤهم في رميهم أهون عليّ من لحنهم وخطئهم في لسانهم”!
ومما يُروى أيضا عن الخليفة عبدالملك بن مروان، خامس الخلفاء الأمويين، أنه كان من القلائل الذين لا يُلحنون لا في جدٍّ ولا في هزلٍ! وكان يردّد في مجالسه: اللّحن في الكلام أقبحُ من التفتيق في الثوب، والجدري في الوجه!
وجاء أيضاً في ترجمة عالم الحضارة الإسلامية الموسوعي أبي الريحان البيروني رحمه الله، إشارة طريفة، تنمّ عن مدى اعتزاز سلفنا السروف من أهل العلم والمعرفة والاستقامة والصلاح، بلغة القرآن والوحي الخاتم، إذ إنه كثيراً ما كان يردّد: والله لئن أُشتَم بالعربية، خير لي من أن أُمدَح بالفارسية!! على الرغم من كونه أوزبكي الأصل!
فأين هذه المعاني الراقية من الأجيال المعاصرة؟ إن الغزو اللساني والثقافي استطاعا تغيير المفاهيم والرؤى والتصورات، حتى ليحسب البعض ـــــ من أبناء جلدتنا ــــــ أن ما أوردناه قبل قليل إنما هو ضربٌ من الأوهام والمبالغات التاريخية التي لا تستقيم مع الأذواق والتصوّرات الحداثية المعاصرة!
ولعل ما يحزّ في النفس والضمير أن الكثير من المعاهد الشهيرة والهيئات العالمية، والدارسين الغربيين، يدركون قيمة اللغة العربية وخصائصها أكثر بكثير مما يدركه أبناؤها!! فهذا المستشرق الفرنسي “ماسينيون” يصرّح بأن “المنهج العلمي انطلق أول ما انطلق باللغة العربية، ومنها انتقل إلى الحضارة الأوروبية، فاللغة العربية أداة خالصة لنقل بدائع الفكر في الميدان الدولي، وإن استمرار حياة اللغة العربية دولياً لهو العنصر الجوهري للسلام بين الأمم في المستقبل”.
ولو كانت مساحة هذا المقال تسمح بالإسهاب والإفاضة لأوردت نقولاً وشهادات لبعض المستشرقين تتضمن إفادات عن عظمة اللغة العربية ومديحاً في خصائصها منقطع النظير. قد تردّ بعض المستلبين حضارياً وفكرياً ووجدانياً إلى جادة الرشد والصواب، لكننا نؤجل ذلك إلى مناسبة قادمة بحول الله تعالى.
اللغة العربية في المجال الدولي:
أما هيئة الأمم المتحدة فقد أدركت منزلة اللغة العربية وخصائصها العجيبة، فجعلتها ضمن اللغات الست المعتمدة لديها. وهي حسب الترتيب الأممي ــــــ والترتيب هنا ربما له دلالته (الإنجليزية ــــ الإسبانية ـــــ العربية ــــــ والفرنسية ـــــــ الروسية ـــــــ الصينية ) وجعلت لكلّ منها يوماً عالمياً للاحتفاء.. فيوم 23 أبريل هو اليوم العالمي للاحتفاء بالإنجليزية، ويوم 12 أكتوبر للإسبانية، ويوم 18 ديسمبر للعربية، ويوم 20 مارس للفرنسية، ويوم 6 يونيو للروسية، ويوم 20 أبريل للصينية.
وقد سارت جميع الهيئات والمنظمات التابعة للهيئة الأممية -كمنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسف وغيرها- على المنوال ذاته من جعل اللغة العربية لغةً رسميةً ضمن اللغات الست الرسمية المعتمدة لديها على المستوى العالمي.
وفي العصور الحديثة نستطيع القول بأنّ مطاردة العربية الفصحى بدأت مع مجيء الاستعمار العسكري إلى ديار العرب والمسلمين، لكنها بقيت متواصلة مع ضراوة الغزو الثقافي واللساني الغربي، ودليل ذلك أن اللغة العربية لا وجود لها في عدة ميادين مثل الفنادق الكبرى، والهندسة والطب والصيدلة وهو أمر يترجم بوضوح عن فشل الذائدين، كما يثبت صحة ما صرختْ به اللغة العربية على لسان شاعر النيل حافظ إبراهيم رحمه الله:
رَمَوْني بعُقْم في الشباب وليتني عقمتُ فلم أجــزع لقــول عِداتي
وسعتُ كتابَ الله لفظاً وغايةً وما ضِقتُ عن آيٍ به وعِظاتِ
أنا البحرُ في أحشائه الدرُّ كامنٌ فهل سألوا الغوّاصَ عن صدفاتي
فيا ويْحكُم أبلى وتَبلى محاسني ومنكم وإنْ عزّ الدواءُ أُساتي
فـــلا تكلوني للزمـــــان فــــإنني أخافُ عليكم أن تحــين وفـــــاتي
وكانت النتيجة الحتمية لضراوة الهجوم وضعف خطط الدفاع، أن ساد التعبير الهابط وغلبت اللهجات السوقية والكلمات الحَوْشية على ألسنة الناشئة، وبهتت ملامح الشخصية العربية، جراء هذه الأخلاط المستغربة في التعبير!
فليعلم أهل لغة الضاد أن اختيار القدر الأعلى للغة العربية وعاءً لحفظ الوحي الخاتم، إنما هو آية وإعلان فصيح صريح عن صلاحية اللغة العربية علمياً وإنسانياً وجمالياً وذوقياً، لحمل قيم ومفاهيم الحضارة وتوجيهها وترشيدها، لأن اللغة التي تتسع لحقائق الغيب والشهادة، لا بد أنها أقدرُ على التعبير عن أيّ مستوى من مستويات تقدم الإنسان وحضارته ومنجزاته، عبر مختلف محطات تاريخه.
كما أن ارتباط العربية بالوحي وخلاصته الأخيرة ــــ القرآن الكريم ــــ هو أشبه بالعملة الورقية المضمونة برصيد من الذهب الخالص. وهذه نعمة جليلة على العروبة يجب أداءُ شكرها، لأن نسيانها، بلْهَ التجهّم لها، إنما هو جريمة تقتضي القصاص في العاجلة قبل الآجلة.
فهل من يقظة جديدة أكثر حرارة ومسؤولية تجاه اللغة العربية، من شأنها أن تُعيد لهذه اللغة العظيمة الجميلة ألقها وجاذبيتها ومكانتها في نفوس الأجيال الناشئة؟ من منطلق الإيمان بمعادلة دقيقة مفادها: أنّ كلّ مَن يَفقد لسانه إنما يُحسبُ في عداد المفقودين حضارياً وثقافياً ووجدانياً، لا سيما خلال هذه الانعطافة الحساسة من تاريخ الإنسانية، التي تداخلتْ فيها الأنساق الثقافية وتمازجتْ فيها المرجعيات بمختلف مكوّناتها وحمولاتها ومضامينها على نحو غير مسبوق.
قرأتُ مقالاً منذ سنوات طويلة ذكر فيه كاتبُه أن الفرنسيين عندما انجلتْ عن أرضهم قوات “هتلر” عقب الحرب العالمية الثانية، أخذوا يفتشون عن أبسط أثر يدلّ على مرور هذه القوة العسكرية فوق أرضهم فلم يجدوا سوى “لافتة” على الطريق مكتوبة باللغة الألمانية فسارعوا إلى إزالتها بكلّ حرارة، إذْ اعتبروها جندياً ألمانياً ما يزال يُشهر سلاحه في وجوههم! يا الله مجرد لافتة من لافتات المرور. فماذا نقول نحن والغزو اللساني واللغوي يكاد يُنسي الأجيال أرومة لغتها العربية الخالدة؟
إنني أمارس التدريس الجامعي وأحياناً أتلفظ عن قصد ببعض الألفاظ العربية التي لا تجري على الألسنة، فكأن قدرها المحتوم أن تظلّ المعاجم والقواميس وقليل من الكتب القديمة هي مسكنها الطبيعي الأوحد! لكن الحيرة تنتابني لأن الطلبة يظلون واجمين دون فهم معنى تلك الألفاظ. بالأمس فقط استعملت لفظ “الرموس: جمع رمس” فقالوا: لم نسمع بها من قبل!! أما حين أستعمل مكان كلمة الأصدقاء لفظة “الأخلام” فإنهم يصارحونني بأنني أكلمهم بلغة لم يسمعوا بها من قبل! فأقول لهم: وكيف يكون حالكم إذن لو كنتم تقرؤون لأبي حيان التوحيدي وعبد الحميد الكاتب والجاحظ وابن عبد ربه الأندلسي وغيرهم من رموز تطريس ديباجة الأسلوب العربي المشرق في الإنشاء والكتابة؟
الحق الذي لا مراء فيه أن واقعنا اللغوي وعلاقتنا بلغتنا أمر يثير اللوعة ويبعث على الأسى والحيرة، لماذا تعتزّ جميع شعوب المعمورة وتفخر بلغاتها وتراثها وماضيها، بينما ننكمش نحن ونخجل من مكوّنات هُويتنا وأرومتنا، على الرُّغم أنها مشرقة ومشرّفة، ولو كانت لدى غيرنا لصنعوا منها الأعاجيب. بل لجعلوا منها مثالاً إنسانياً يُضرب في المجالس والمنتديات.
والأغرب من ذلك كله -ويا للأسف- أنّ بعض الناس الواقعين في دائرة الإلحاق الفكري واللساني والحضاري ـــــ هداهم الله إلى الحق والرشد ـــــ يفتخرون في بعض المجالس والمناسبات بأنهم لا يعرفون [ العربية ] ( كذا والله ) وكأن ذلك في زعمهم يُسلكهم في مسالك ” المتحضّرين “! وغاب عن هؤلاء الحمقى أنّ ” عزّة الذات ” التي يبحثون عنها إنما تكمن في لغتهم وهُويتهم لا في لغة وهُوية غيرهم “وكم عزّ أقوامٌ بعزّ لغاتِ”.
إن لغتنا -لغة الوحي الخاتم- تستغيث وتنادي:
أيهجرني قومي عفا اللهُ عنهُمُ إلى لغـــة لم تتصــــل برواةِ؟
سَرَتْ لوثةُ الإفرنج فيها كما سرى لعابُ الأفاعي في مسيل فراتِ
فجاءت كثوبٍ ضمَّ سبعين رقعةً مُشكّلـــــة الألـــــوان مُختلفاتِ
فهل من هبّة نتجاوز بها العلاقة العاطفية تجاه اللغة العربية، وندلف من خلالها إلى ما يجب علينا عملياً كي لا يظلّ التلبّك في الموقف هو سيد الحال؟
والله ولي التوفيق..
______________________________________
(*) كاتب وأستاذ جامعي – جامعة الشيخ العربي التبسي – الجزائر
