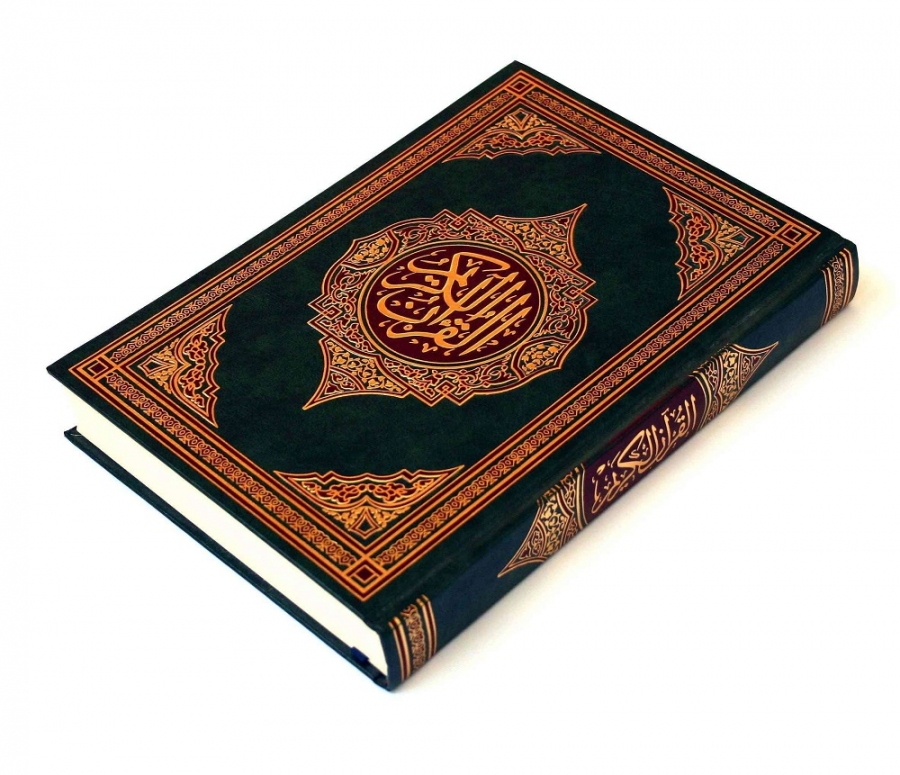شهد العصر الحديث انفجاراً علمياً لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، وشهدت وسائل الاتصال الحديثة وعوامل أخرى تداخل العلوم وترابطها وخصوصاً في مجال علوم الطبيعيات والطب وعلوم الحياة والفلك.. إلخ.
هذه الحقائق والتي يريد أن يطبقها كثيرون على مسألة ربط نصوص بعض الآيات القرآنية بالعلوم الحديثة ربطاً مبالغاً فيه، ولا مبرر له تحت مظلة أن هناك سيلاً من الإشارات القرآنية تؤيد هذه المزاعم، ناسين أن القرآن الكريم كتاب إعجازي لا مثيل له ككل، ولا يحتاج إلى تفاصيل مملة لا تعني شيئاً للعامة، وحقائق علمية لا يفهمها إلا أهل الاختصاص، وأنه كلام الله تعالى، فالعلم ليس ثابتاً مهما تطور، ونحن لا نعيش في آخر الأزمان لنقر بأن كل ما وصلنا صحيح تنطبق عليه الإشارات القرآنية التي تهتم أصلاً بمسألة الحياة والخلق.
فالخالق جل شأنه في المعتقد الإسلامي واحد، ليس كمثله شيء، ومبدع كل شيء، ولا يمكن أن يكون الخلق إلا متكاملاً ومحكماً، وقد لفت لذلك الأمر القرآن الكريم بمناشدته لأولي الألباب بربط الخلق بخالق متفرد لا يلد ولا يولد، وأن الأمر هو جزء رئيس من العبادة الفكرية التي يجب أن تلازم إيمان المسلم أياً كان مستوى تعليمه وثقافته؛ لأنها مسألة فطرية لا خلاف حولها، ليرقى إلى درجة الإيمان المطلق وهو أعلى درجة من الإسلام فقط.
وهناك عشرات الأمثلة في القرآن تشير بوضوح لا لبس فيه إلى هذه المسألة، يقول تعالى: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ {190}) (آل عمران)، ويقول: (أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ) (الأعراف:185)، ويقول: (يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {17}) (المائدة)، وغيرها من الآيات الكريمة الكثير التي تؤكد إجمالية فكرة الخلق، وأن الأمر ليس من باب الصدفة، فالصدفة لا ينتج عنها خلق متقن.
وعليه؛ فمسألة الخلق كلها بالنسبة للمخلوق سواء أكان مسلماً أم غير مسلم مسألة إعجازية لا يمكن النظر إليها من باب الأسرار التي لا يمكن فهمها كما تفعل المسيحية، عندما تضع كل شيء بالمعتقد المسيحي في باب الأسرار المبهمة والتي تنتهي عندها مهمة العقول، ولكنها مسألة عقلانية فكرية حدودها الفهم العميق الذي يفرق بين مفهومي الخالق والمخلوق، أياً كان هذا المخلوق؛ حيث يقف على قمة هرم المخلوقات الإنسان الذي كرمه الله بقوله: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً {70}) (الإسراء)، والربط بين التكريم والخلق واضح لا لبس فيه، وبوضع الآية في الإطار الفكري للآيات السابقة تتكامل الصورة الاعتقادية من ربط هذه الأمور ببعضها ربطاً متكاملاً في إطار تعزيز فكرة أن كل شيء مصدره عملية الخلق التي لا يقوم بها إلا الله تعالى وحده بصورة غير مدركة من قبل المخلوقات.
وعليه؛ فالمعجزة التي يمكن فهمها كأمر خارق للعادة يعجز الإنسان عن فعله، ستقع ضمن دائرة الذي يتفرد به الله تعالى بحكمة بالغة، وتكون مسألة بديهية لا تحتاج إلى تفاصيل العلم القديم أو الجديد لتأكيدها؛ لأن هذا العلم مهما كان لا يرقى لعلم الله الذي يقول: (وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً {85}) (الإسراء)، وإن بعض المفكرين كابن تيمية ومن يقلده لا يستسيغ كلمة معجزات ويستبدلها بمصطلح “آيات”، استناداً لبعض الآيات القرآنية مثل: (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) (فصلت:37).
وعلى هذه الأسس يجب ألا تتحول نظرتنا للتقدم العلمي إلى نظرة إعجاب على أسس دينية أو نتيجة الانبهار بالمكتشفات الجديدة، ثم فرض آراء توفيقية لربط العلوم الحديثة بالقرآن، وإثبات أنه مصدر كل شيء، استناداً لتأويل خاطئ للآية: (وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ {38}) (الأنعام)، فالآية الكريمة تتعلق بأمور العقيدة الأساسية، وأهمها إقرار التوحيد ونبذ الشرك، فالعلم مهما تقدم ليس ثابتاً وكل جديد فيه تغيير، وقد ما يأتي اليوم يسقط غداً.
لقد أهمل الساعون إلى تركيز فكر الإعجاز العلمي وجعلوا الأولوية له على فكرة الخلق ككل، فقالوا: إن هذه الإشارات الإعجازية تشكل الدليل القاطع على أن مصدر القرآن هو الله تعالى، وأن النص القرآني يتوافق مع العلم الحديث بحيث صارت النظرة للأخير نظرة مقدسة! وهم يهملون كلام الله الذي لا يحتاج لبراهين علمية أو تاريخية لإثباته حتى ذهب البعض لتأويل الآية الكريمة: (لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ {67}) (الأنعام)؛ بأن ما ورد في القرآن من معلومات علمية، سوف يكتشف مع مرور الزمن، وهذا غلو وتفسير قسري لا معنى له.
لقد عرفت هيأة الإعجاز العلمي في القرآن والسُّنة، الإعجاز بأنه حقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إدراكها بالوسائل البشرية في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما أخبر به ربه، وهذا التعريف عجيب، فكأنما كان هنالك شك لدى القرون القديمة بمصداقية القرآن، فجاء العلم الحديث ليزيل هذا الشك.
وإذا قبلنا بهذه القاعدة فعلينا مراجعة كثير من التفاسير والأحاديث التي تشير لهذه الآيات الربانية، والتي لا تهتم بالتفاصيل الجزئية التي أفرزها العلم الحديث، وهو منهج لا يقر به القرآن عموماً من حيث عدم اهتمامه بكل التفاصيل والجزئيات في مجريات الخلق وقصص الأنبياء وتفاصيل أخرى لا تقدم ولا تؤخر.
لقد بولغ في كثير من الدراسات حول ربط الحقائق العلمية المكتشفة بمسألة الإعجاز، فيكتب أحد الباحثين عن ثمرة التين وشجرتها وكل ما يتعلق بها وما تحتويه من قيم غذائية وفيتامينات وأملاح، لأن الله تعالى أقسم بها.
وبحثاً آخر يشرح لنا بالتفصيل الممل تحول الطعام الذي يتناوله الحيوان من دخوله الأمعاء إلى خروجه من الضرع كلبن سائغ للشاربين، والعملية تنطبق لو أردنا على ميكانيكية كل عمل الأجهزة البيولوجية من سمع وبصر وتذوق ونمو وتنفس، وأن ربط هذه الأشياء كمعجزات تؤكد مصداقية القرآن لا تقع إلا ضمن دائرة الخلق المتقن ولا غير، والخلق كله محكم من الله لأنه بديع السموات والأرض التي يعيشها البشر منذ ولادتهم حتى وفاتهم، أما التفاصيل الدقيقة فلا يدركها إلا أصحاب الاختصاص، وعندها لا تعني عندهم شيئاً ولا يدركها غيرهم من أهل العلوم أو العامة وتفقد مصداقيتها تماماً.
لقد سرى الأمر حتى على العلوم الهندسية والطبيعية فراح أحدهم، وفي كتاب لا يقل عن 200 صفحة يشرح لنا ميكانيكية سريان الماء داخل أنواع الترب المختلفة، ثم يضعه في دائرة الإعجاز العلمي الذي جاء به القرآن!
إن محاولات تفصيل الحقائق العلمية وإسقاطها على الإعجاز القرآني هي محاولات مملة وعقيمة، وهذا الطريق هو طريق أنصاف المثقفين دينياً، وأنصاف المتعلمين علمياً، وهي محاولات تزيين الفكر الديني بالانبهار العلمي بدون تبريرات، خصوصاً لدى المؤمنين بقدرة الخالق تعالى الذي أحسن كل شيء صنعه، ولا تترك لدى الماديين والملحدين أثراً ذا قيمة لأنهم أصلاً لا يؤمنون بالخالق تعالى.
إن مهمة القرآن الكريم وهو بالأساس كتاب هداية، والتأكيد كما أسلفنا على توحيد الخالق ونبذ الشرك، حتى لو كان ضمن وحدة الوجود التي تضع الخالق والمخلوق في كيان واحد تحت غطاء لا موجود إلا الله، ثم وضع البشر في محل تكريم يقر بقدرة الخالق بدون التفاصيل العلمية غير الثابتة.
وأخيراً؛ فإن كل المخلوقات تقر بهذا الشيء بطريقة لا ندركها لأنهم أمم أمثالنا، وأن كل ما في الوجود يسبح لله لأنه خلقه، وأن الأمر فطري لا نحمله أكثر مما يستحق، فالخلق من الله الذي أتقن كل شيء بمقاييس ربانية.
إنها رسالة قصيرة لإبقاء النص القرآني ضمن التفكير العقلاني المتوازن، وعدم الجنوح للفكر الإعجازي بالحجج العلمية التي لا طائل من ورائها إلا تشتيت فكر العامة وخلط الأمور عليهم.